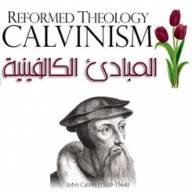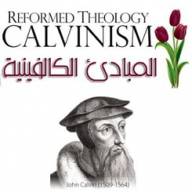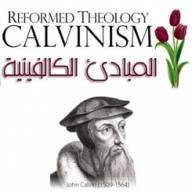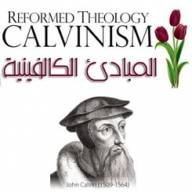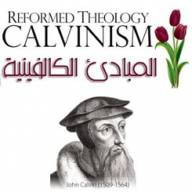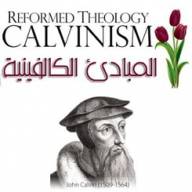في كتابها ’’وتذكرت‘‘، أوردت الكاتبة إميلي الراسي قصة رجل بروتستانتي استدعي إلى اسطنبول لأمرٍ ما؛ سأله المسئول عن هويته ومذهبه، وسأله أيضًا ما إذا كان متعلمًا أم أمّيًا؟ فاحتد الرجل، وحسب السؤال إهانة له، وقال: ’’كيف تسألني هل أنت متعلم أم أمّي؟ ألم أقل لك إني بروتستانتي؟ وهل يعقل أن أكون أمياً؟‘‘ وسحب الإنجيل من جيبه. هذه القصة الطريفة تقدِّم إلينا مثالًا على مدى ارتباط اسم البروتستانت، أو الإنجيليين، بالعلم والتربية. وهذه حقيقة يعرفها كل مَنْ يعرف تاريخ الإصلاح الإنجيلي والمرسلين الإنجيليين. فأينما انتشروا انتشرت المدارس والجامعات، فساهموا في النهضة الثقافية والحضارية في المجتمعات. ولكن السؤال هو: ما الذي قاد المصلحين الإنجيليين إلى الاهتمام بالتربية، واستطرادًا إلى فتح المدارس؟ عندما بدأ الإصلاح الإنجيلي، انطلق مِنْ اختبار روحي عميق قام به مطلق الإصلاح مارتن لوثر. ذاك الاختبار الذي غيّر حياته تأسس على الكتاب المقدَّس الذي صار له ولباقي المصلحين الإنجيليين المصدر الوحيد للعقيدة والإيمان والحياة، وبالتالي ركيزة تفكير المصلحين، وموضع بحثهم. Reformationheuteoriginal
هكذا قام المصلح لوثر بترجمة الكتاب المقدَّس مِنْ اللغة اللاتينية إلى لغة الشعب الألمانية، وبذل المصلحون جهودًا كبيرة لإيصاله إلى الناس، لكي لا تفوتهم رسالته التي تدعو الجميع إلى الحياة الفضلى بالإيمان بالرب يسوع المسيح. ولكن كيف يتعرف الناس إلى الكتاب المقدَّس إنْ لم يتعلموا القراءة والكتابة؟ لا بد مِنْ المدارس. وهكذا عملوا على إنشاء المدارس لتعليم الناس القراءة والكتابة، وليتعرّفوا إلى الأخبار السارة واللآلئ الثمينة التي يتضمّنها الإنجيل.
إلا أنَّ الأمر الأساسي الآخر الذي ساهم في اقتران اسم الإنجيليين بالعلم، هو شخصية المصلحين الإنجيليين الذين حملوا لواء الإصلاح، ومنهم اثنان مارسا دورًا كبيرًا في إرساء الفكر الإنجيلي التربوي لتأسيس المدارس والجامعات الإنجيلية وهما: المصلِّح الألماني مارتن لوثر، والمصلِّح الفرنسي جان كلفن. فالأول كان مربيًا واستاذًا جامعيًا في حقل اللاهوت. مِنْ أهم الدوافع التي قادته إلى الإصلاح مزيج مِنْ صراع روحي فكري أدى به إلى التركيز في دراسة الكتاب المقدَّس في عمق بلغاته الأصلية التي كُتب فيها، وهي العبرية للعهد القديم واليونانية للعهد الجديد. وهذا التشديد ظهر في الجامعة التي علّم فيها، إذ طرأ تغيير على مناهجها شمل التشديد على اللغات. وهكذا مع المصلِّح لوثر رافق الإصلاح الإنجيلي التشديد على اللغات والتعليم، ليس فقط في المدارس، بل في الجامعات.
أما المصلح كلفن، فكان محاميًا يحمل شهادة الماجستير في الحقوق. صرف الوقت الطويل ينهل من ينابيع الثقافة والفلسفة ما رآه مناسبًا ومفيدًا. أعجب بما قاله الفيلسوف أرسطو وبعض الفلاسفة اليونانيين القدماء مِنْ أنَّ هدف التربية اكتشاف الفضائل والأخلاق. واعتبر أنَّ هذا التفكير ما هو إلا تحضير لاستقبال حقائق الإيمان المسيحي، لكنه حذَّر مِنْ الموافقة على كل شيء يقوله الفلاسفة. استخدم كلفن علم المنطق والتحليل الذي استقاه مِنْ الفلاسفة ليكون أسلوبًا منهجيًا يطبقه على دراسة الكتاب المقدَّس وتفسيره. كما كان من القادة التربويين الذين ساهموا في تنمية التعليم العالي. ففي عام 1559م، وحين كان في جنيف، أسس مدرسة تحضيرية سُميَت لاحقًا College Calvinومعهد للدراسات العليا أطلق عليه اسم Academiaتحوَّل في ما بعد إلى جامعة جنيف.
وهكذا، مِنْ الكتاب المقدَّس، حجر الأساس لكل دراسة وتعليم، انطلق الإنجيليون إلى العالم حاملين كلمة الله التي لا تغيّر القلب فحسب، أي الجانب الروحي مِنْ الإنسان، بل كل الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله. وهكذا أيضًا وصل المرسلون الإنجيليون إلى لبنان في بداية القرن التاسع عشر. وقد تكرر الاختبار ذاتهُ الذي جرى مع المصلحين الإنجيليين الأوائل، فعملوا على ترجمة الكتاب المقدَّس إلى اللغة العربية مِنْ اللغات الأصلية، ورأَسَ مشروع الترجمة المرسَل القس الدكتور عالي سميث عام 1847م، وعاونه الاستاذ بطرس البستاني والشيخ ناصيف اليازجي. وبعد 9 سنوات مِنْ وفاة القس سميث، خلفه القس الدكتور كورنيليوس فانديك، الذي أنهى العمل عام 1865م، فسُميَت الترجمة ترجمة (فانديك – البستاني)، وهي الترجمة المعتمدة مِنْ الكنائس الإنجيلية. ثم توجّه المرسلون الإنجيليون بالكتاب المقدَّس لتأسيس الكنائس والمدارس جنبًا إلى جنب في الكثير مِنْ المناطق اللبنانية والسورية؛ وكانت المدرسة آنذاك عبارة عن غرفة أو بعض الغرف القليلة، إذ كان المرسل أو الواعظ هو نفسه المعلم. وقد قارب عدد المدارس في مرحلة ما، المئتين وسبع وسبعين مدرسة في سورية ولبنان، إلا أنها تجمَّعت في مرحلة لاحقة في مدارس كبيرة. وأفاد لبنان مِنْ التنافس التربوي ما بين الإرساليات اليسوعية، التي نشأت نتيجة الإصلاح الكاثوليكي المقابل منذ عهد الإصلاح الإنجيلي في القرن السادس عشر، والإرساليات الإنجيلية، التي أتت إلى لبنان في بداية القرن التاسع عشر. وقد نقل عن المرسَل الدكتور كورنيليوس فانديك قوله: ’’أنا ذاهب لأؤسّس مدرستيْن في القرية الفلانيّة‘‘. وعندما كان يُسأل لماذا مدرستان؟ كان يجيب، ’’عندما أؤسس مدرسة إنجيلية يسارع اليسوعيون إلى تأسيس مدرسة كاثوليكية‘‘. وهذا الأمر انسحب أيضًا على الجامعتيْن الأميركية واليسوعية. فعندما أسس الإنجيليون الجامعة الأميركية، التي كانت تُعرَف آنذاك بالكلية الإنجيلية السورية عام 1868م، أسس اليسوعيون الجامعة اليسوعية عام 1875م.
وبخصوص المدارس، فقد أسس الإنجيليون عام 1835م أول مدرسة (تحمل طابع المدرسة، حيث يجري التعليم داخل جدران الصف) لتعليم الفتاة في كل مناطق نفوذ السلطة العثمانية، اسمها ASGالمدرسة الأميركية للبنات، التي كانت في ساحة رياض الصلح، ثم انتقلت عام 1974م إلى منطقة الرابية، وأتّخذت اسم مدرسة بيروت الإنجيلية للبنات والبنين. ثم توالى بناء المدارس الإنجيلية، فتبعتها مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا عام 1862م، وغيرها الكثير مِن المدارس. والآن يوجد في لبنان أكثر مِن 45 مدرسة إنجيلية (بعضها يتبع كنائس إنجيلية، وبعضها الآخر يتبع أفرادًا إنجيليين). وفي مرحلة لاحقة، اقتنع المرسلون الإنجيليون اللاحقون بأنَّ الكتاب المقدَّس لا يخاطب فقط الجانب الروحي مِن الإنسان بل يخاطب كلَّ الإنسان، المخلوق على صورة الله ومثاله؛ يخاطب شخصيته ليصقلها ويجعله إنسانًا قادرًا على اتخاذ القرارات المناسبة؛ يخاطب فكره لينميه ويكشف مواهبه وإمكاناته الكامنة فيه، يخاطب إرادته ليدرّبها فيصير مسئولًا عن تصرفاته؛ ويخاطب مواقفه ليجعلها منسجمة مع قيم الإنجيل الروحية والأخلاقية، وهكذا يتحقق كيان الإنسان الكامل.
وبدخول المدارس والجامعات الإنجيلية إلى لبنان، دخلت اللغة الإنكليزية وانتشرت في مناطق كثيرة. وقد أدت هذه المدارس والجامعات دورًا تربويًا رائدًا، إذ ساهمت في النهضة الثقافية العربية، ليس في لبنان فحسب، بل في الشرق الأوسط، وعُرِفَت بوطنيتها ونبذها الطائفية، إذ استقبلت منذ تأسيسها كلَّ تلميذٍ مهما يكن دينه أو عرقه أو لونه؛ فعُرِف متخرجوها مِن أصحاب الفكر الحر، والوطنية الملتزمة التي عملت مِن أجل بناء الوطن الواحد.